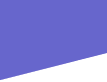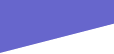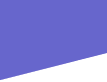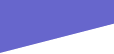|
هل يحكم لبنان
حالياً بقوة القرار السياسي
ام بقوة الدستور ؟
وهل ان ما يجري
داخل نظام الحكم اللبناني
يعطي الأولية للقرار
السياسي، على ان يتم ‹‹تدبير››
الدستور بعد ذلك ؟
ان اخطر ما في
تراجع عمل المؤسسات هو
الايحاء باحترام الدستور
عبر الاكتفاء بالشكل،
لأن الدساتير وجدت كي
تشكل حاجزاً ضد القرار
المفروض، وليس كي تصبح
وسيلة مشوهة لتنفيذه.
فمن عملية تأليف
الحكومة الجديدة، الى
عملية تعديل الدستور
وتمديد ولاية رئيس الجمهورية،
اين كان الوفاق مما جرى؟
وما هو واقع نظام الحكم
الذي يعيشه لبنان ؟
اعضاء الحكومة
في النظام الديموقراطي
السليم، لا يأتون من العدم.
واذا كان بعض الوزراء
وُصفوا بالمجهولين،
فهذا يعني انهم غير معروفين
في مجال العمل السياسي.
لأن النظام السياسي عندنا
وعند سوانا، اذ يتيح
ادخال عناصر من غير السياسيين
المعروفين الى فريق العمل
الحكومي، يفترض ان يتم
ذلك على اساس ما انجزه
هؤلاء على الصعيد المهني
داخل المجتمع المدني،
بما يبرر توظيف نجاحهم
الخاص في المجال العام.
أما ان يتم تعيين
اشخاص مجهولين سياسياً
ومجتمعيا، فان ذلك يطرح
السؤال عن المقياس الذي
يعتمد في تعيينهم، لأن
مكافأة الجهد تبدو اذذاك
في غير موضعها، لكون صاحبها
كوفئ على جهود لم يبذلها
او لم ينجح فيها.
والاستعانة
باشخاص من خارج السياسة
ومن خارج البرلمان أمر
مقبول من حيث المبدأ،
وبخاصة في لبنان، حيث
درج التقليد منذ اواسط
الستينات على تطعيم الحكومات
بوزراء غير سياسيين،
او تأليف حكومات كلها
او معظم اعضائها من خارج
المجلس النيابي، في ما
سماه بعض الإعلام حكومات
‹‹ اكسترا برلمانية››.
وكان الهدف من ذلك إتاحة
المجال من جهة امام وجوه
جديدة كفؤة يتزايد عددها
يوماً بعد يوم في لبنان،
بسبب تنامي الاختصاصات
وتعددها في الداخل والخارج،
ومن جهة أخرى تليين الممارسة
داخل النظام اللبناني
المقفل على عدد غير قليل
من ابناء العائلات وورثتهم.
وفي غياب نظام حزبي فاعل
ونظام انتخابي منفتح
ومتجدد، لم يكن هناك من
مجال غير تعيين بعض الناجحين
في المراكز الحكومية.
على ما لذلك من انعكاسات
غير قليلة على الجسم المهني
للوزير المعين، لأن السؤال
المشروع لا يلبث ان يأتي
: لماذا هذا الطبيب وليس
غيره؟ ولماذا هذا المهندس
وليس غيره؟ وهذا الجامعي
وليس غيره؟
ومع ذلك درجت
العادة، لا بل اصبحت
مطلوبة.
فعندما تألفت
الحكومة الأولى في عهد
الرئيس سليمان فرنجية،
في ايلول 1970، برئاسة الرئيس
صائب سلام، أُطلق عليها
لقب ‹‹حكومة المجهولين››،
لأن غالبية اعضائها كانوا
من غير السياسيين. لكنهم
كانوا من اصحاب الاختصاص
في الطب والمحاماة والهندسة
والاقتصاد، علماً بأن
غسان تويني كان من بينهم،
وهو من اكثر المعروفين.
وعندما تنشر
سير حياة الوزراء المجهولين،
ويتبين للرأي العام ان
الوزير الجديد حقق الكثير
في حياته المهنية والاجتماعية،
يتبرر تعيينه، و يقابل
عادة بالارتياح والتشجيع،
لأنه مرادف للتغيير،
وهو الأمر المطلوب دائماً
في الشأن العام. ولا يزال
الرأي العام اللبناني
يذكر بكثير من التعاطف
والتقدير الوجه المحبب
للمرحوم الدكتور اميل
بيطار، الذي عين وزيراً
للصحة في “حكومة المجهولين”.
ولكن عندما يتبين
تعيين بعضهم من دون مبرر
يُطرح موضوع الدافع السياسي
لذلك وموضوع سلم القيم
ايضاً، لأن اختلال سُلّم
القيم اذا اضيف الى اختلال
احترام الدستور، يطرح
موضوع نظام الحكم اللبناني
ككل، وانتقاله من حال
الى حال.
وبعد الممارسات
التي تجري في لبنان منذ
بضع سنوات، اصبح صعباً
تحديد مواصفات نظام حكمه.
ذلك ان اخطر
ما في تراجع عمل المؤسسات
هو الإيحاء باحترام الدستور
عبر الاكتفاء بالشكل،
لأن ذلك هو أسوأ انواع
الخروقات. فوظيفة الشكل
ان يحمي الجوهر لا ان يدمره.
والدستور، بروحه
واعرافه، هو في الحقيقة
روح البلاد ونبض الأوطان.
والاكتفاء بحرفية النص
وحدها، خدمة لأغراض ومصالح
سياسية، ليس كافياً لحماية
الدستور.
والدستور اللبناني
وضع كي يكون جامداً وغير
قابل للتعديل. وكي يصبح
مرجعية ثابتة لا بديل
منها. وكان آباء الدستور
المؤسسون واسعي الحكمة
عندما ارادوا ان يحموا
المجتمع المتعدد الطائفة
في وقت واحد من اخطار التسلط
الداخلي واخطار المداخلات
الخارجية. لأنه ثبت بالتجربة
انه اذا لم تكن للبنان
مرجعية ذاتية، فان مرجعية
خارجية تحل محلها. والمرجعية
الذاتية لا يمكنها ان
تكون غير الدستور.
وقد اجتاز لبنان
العصر و الحرب دون الاستهانة
بالدستور، حتى في حالات
الخروج على الشرعية في
سنوات الحرب، لأن هناك
ربطاً بينه وبين الكيان
نفسه، كونهما نشآ في فترة
زمنية واحدة بين 1920 و
1926. وتبين ان هذا الإطار،
اي الدستور، هو وحده الكفيل
تحقيق الغرض من اقامة
الدولة، وجمع المجتمع
في صيغة توافقية ديموقراطية.
لهذه الأسباب،
اكثر ما يخشى منه على
صعيد الممارسة الجارية،
هو اخضاع الدستور للقرار
السياسي والاكتفاء بعد
ذلك ‹‹بتدبير›› الأمر،
اي بايجاد المخرج الذي
يراعي الشكل.
فقبل ايام عدة
من استقالة الحكومة السابقة،
كان الوسط السياسي والإعلامي
يتداول اسم رئيس الحكومة
الجديد واسماء الوزراء،
علماً بأن الاستشارات
الملزمة التي يقوم بها
رئيس الجمهورية اريد
لها ان تكون نوعاً من انتخاب
غير مباشر لرئيس الحكومة،
عبر تيارات مجلس النواب
التي تعكس تيارات البلاد
السياسية، واخراج موضوع
تعيين رئيس الحكومة من
استنسابية رئيس الجمهورية،
كما كان الحال في ظل الدستور
السابق. وعلى كل، ثمة بعض
الدول - مثل اسبانيا - حالياً
ومثلما كان معمولاً به
في عهد الجمهورية الرابعة
في فرنسا، اشترطت الموافقة
المسبقة للبرلمان على
تسمية الرئيس المكلف
قبل عملية التأليف، وبالطبع
قبل الحصول على الثقة.
لكن هذا الإجراء
الدستوري المفترض ان
يجري العمل به في لبنان،
اصبح يسبقه بأيام عدة
تداول معلن لاسم الرئيس
المكلف واسماء الوزراء،
بما يعطل عملياً مفهوم
الاستشارات وفلسفة الشورى
والأخذ برأي الآخر، لتحل
محلها كلمة سر ما، توحي
الاسم فتردده غالبية
مطلوبة.
وحده العميد
ريمون اده، حسبما يذكر
التاريخ القريب، تمرد
في ايلول 1958على الاتفاق
المصري - الأميركي القاضي
بانتخاب فؤاد شهاب رئيساً
للجمهورية، فاعلن ترشحه
ضده، ليس طمعاً بالفوز
كما اعلن في جلسة مجلس
النواب الانتخابية، بل
في سبيل الممارسة الديموقراطية،
والحؤول دون القرار الواحد،
حتى لو كان متفقاً عليه
من القوتين الدولية والإقليمية.
فالدساتير وجدت
كي تشكل حاجزاً ضد القرار
المفروض، وليس كي تصبح
وسيلة مشوهة لتنفيذه.
وما ينطبق على
عملية تأليف الحكومة
سبقه إجراء تعديل الدستور،
بالطريقة التي خلفت آثاراً
داخلية وخارجية عديدة
وعميقة لم ننته منها بعد،
وليس ذلك لأن الدستور
قد عدّل، بل لأن تعديله
حصل في جو غير وفاقي.
فاذا كان الدستور
أعطى رئيس الجمهورية
حق اقتراح اعادة النظر
في الدستور، في المادة
76 منه، فان المشترع الدستوري
عام 1926، يوم أدرج هذا الحق،
انما فعل ذلك اولاً من
ضمن الصلاحيات الواسعة
التي اعطيت يومذاك لرئيس
الجمهورية، وثانياً من
ضمن الحرص على عدم اقفال
الباب في صورة محكمة امام
التعديل، اقله لحال طارئة،
بعد الآلية الشديدة التعقيد
التي نصت عليها المادة
77 اللاحقة. علماً بان استعمال
حق رئيس الجمهورية أُخضع
لشرط موافقة مجلس الوزراء،
الذي يمكنه ان يرفض ولا
يمكنه ان يطلب التعديل،
بما يشير الى ان المشترع
لم يخطر بباله اطلاقاً
ان رئيس الجمهورية سوف
يمارس هذا الحق طلباً
لتمديد ولايته او لتجديدها،
ذلك ان مبدأ الأخلاقية
الدستورية éthique constitutionnelle يمنع
ذلك، وان الدستور نفسه
في مادة مشابهة هي المادة
63، التي تحظر على رئيس الجمهورية
الإفادة من تعديل تعويضاته
مدة ولايته، يمنع تالياً
رئيس الجمهورية من ان
يطلب شيئاً لنفسه. الدستور
هو الذي يمنع وليست ارادة
رئيس الجمهورية.
أما المادة 77
اللاحقة، بالتشدد الاستثنائي
الذي انطوت عليه للتعديل،
فتدل على أن الدستور مثلث
الجمود، يشترط اولاً
موافقة ثلثي الأعضاء
الذين يتألف منهم المجلس
قانوناً على اقتراح النواب
العشرة، وموافقة ثلثي
الحكومة ثانياً على مشروع
قانون التعديل، وموافقة
ثلاثة ارباع الأعضاء
الذين يتألف منهم المجلس
قانوناً بعد ذلك، مع ذكر
مهلة الأربعة اشهر التي
يمكن الحكومة معها وضع
مشروع التعديل وامكان
طلب رئيس الجمهورية حل
مجلس النواب اذ اصر المجلس
على التعديل.
فمن يضع آلية
معقدة من هذا النوع لا
يقصد تحقيق الجمود للجمود،
بل لكي يحوط الدستور،
وهو مرجعية الجميع، بأعلى
قدر من الصيانة، وكي يجعل
مسألة تعديله، وهو القانون
الأسمى، تحظى باوسع وفاق
ممكن، ترجمة لصيغة العيش
المشترك، في ما يتجاوز
الأكثرية العددية النيابية
التي لم يعد تأمينها صعباً
كما شاهدنا في اكثر من
مناسبة. لأن لبنان لا يساس
بالمفروض والإكراه والتسلط
والاستئثار والاستفزاز.
ولأن قواعد الحكم في لبنان
الناشئة عن تكوين المجتمع،
متمثلة بالشورى، في احد
ابرز اوجهها، وليس بفرض
الرأي وفرض القرار. لذلك
كان الترابط وثيقاً بين
الدستور والوفاق، وهما
قاعدتا نظام الحكم اللبناني.
وهكذا يتبين
ان روحية الدستور هي واحدة
في مختلف مواده، ولا يمكن،
بل لا يجوز انتقاء مادة
معينة وضعت لأهداف ولظروف
معينة، واستعمالها لغير
مراميها الحقيقية.
لقد حصل التعديل
وتم التمديد لرئيس الجمهورية،
وحصلت ردود فعل دولية
لا سابق لها، واصبحنا
رسمياً على نزاع مع مجلس
الأمن الدولي، وعلى سجال
غير ودي مع اميركا ومع
فرنسا، علماً بأن لبنان
هو من واضعي ميثاق سان
فرانسيسكو في نيسان 1945 الذي
اسس منظمة الأمم المتحدة.
وهو صديق للولايات المتحدة
رغم المآخذ على سياستها
الخارجية الظالمة في
منطقة الشرق الأوسط،
والتي ظلمت لبنان لسنوات
طويلة، كما انه صديق تاريخي
وتقليدي لفرنسا.
لقد كنا في غنى
عن كل ذلك بالطبع. كنا في
غنى عن ارتفاع اصوات
بالتهجم وشتم اصدقاء
تاريخيين للبنان، صداقته
معهم هي جزء من حضارته،
وليس من جواب لدينا الا
اتهام اميركا وفرنسا
والمنظمة الدولية بالتدخل
في شؤوننا الداخلية،
والقول بأن التمديد بات
وراءنا مثل من لا يريد
ان يسمع او ان يرى، الى
حد ذهاب بعضهم الى وصف
الحكومة الجديدة بأنها
حكومة مواجهة، مواجهة
مع المجتمع الدولي.
كل ذلك لأن ما
جرى خلال الصيف المنصرم،
لا بل خلال السنوات الماضية،
لم يتم وفقاً لما تقتضيه
اصول العمل على صعيد ممارسة
الحكم. ولذا فان العبث
بالدستور وتعريض الوفاق
للاختلال ليس شأنهما
في لبنان مثل شأن اي بلد
آخر، مهما قيل عن ان الدستور
ليس منزّلاً.
واذا كان الدستور
وضع على مدى اكثر من ستة
عقود في مرتبة الاحترام
القصوى، فليس ذلك لأنه
المرجع الأسمى فحسب،
بل لأن احترام الدستور
هو الشرط الأساسي في لبنان
للانتقال من مجتمع الميثاق
الى دولة المؤسسات. ولأن
لبنان، المتعدد الطائفة،
ومجتمعه البشري حال فريدة
في العالم لا يمكنه ان
ينصهر في اكثرية واضحة
لها انعكاسات سياسية
مثلما هي الحال في بلدان
مجاورة او بعيدة. ولذا
نادى كبار المنظرين في
الشأن اللبناني، في عيد
الاستقلال، بوجوب العمل
على بناء الدولة، الذي
كان شعار فؤاد شهاب اكثر
من غيره، وهو المطلب الاساسي
الذي ظهر بعد انتهاء الحرب
ايضاً. ولكن هنا بدأ التباين
وبدأ انسلاخ الظاهر عن
قواعد العمل التقليدية
والمفيدة في لبنان، وذلك
من خلال التصميم على تغيير
معالم الحياة السياسية
اللبنانية، باسم اعتبارات
مختلفة. فلقد تم تفكيك
قطار النظام السابق،
ولم يوضع على الخط قطار
صالح للسير بدلاً منه.
والنتيجة الظاهرة
للعيان بوضوح ان السلطات
متداخل بعضها ببعضها
الآخر في شكل يضرب الديموقراطية
السياسية في الصميم،
وان المسؤولين عن المؤسسات
الدستورية لا يتقيدون
بالصلاحيات التي فوضهم
اياها الدستور، بحكم
واقع سياسي يتجاوز شروط
اللعبة السياسية الداخلية.
ولو اقتربنا
اكثر من الواقع الحالي
لتبين لنا على سبيل المثال،
وبخاصة بعد قرار تعديل
الدستور وتمديد ولاية
رئيس الجمهورية، انه
كانت هناك محاولات واضحة
لتقوية سلطة رئيس الجمهورية.
وساعد في ذلك اسلوب الرئيس
اميل لحود نفسه منذ انتخابه
واعلانه ما اعلن في خطاب
قسم اليمين الدستورية،
وهو خطاب لا يشبه اياً
من خطب رؤساء الجمهورية
السابقين، حتى في ايام
الصلاحيات الفعلية. اذ
بدا ان الرئيس لحود، منذ
اللحظات الأولى، يريد
ان يحكم او جاء ليحكم
في الوقت الذي نص فيه الدستور
على ان السلطة الاجرائية
منوطة بمجلس الوزراء.
وكانت الإشارة
البارزة الى ذلك من رئيس
الجمهورية اصراره على
ترؤس جلسات مجلس الوزراء،
في ايام حكومتي الرئيس
رفيق الحريري، علماً
بأن الدستور الذي قال
ان بامكان رئيس الجمهورية
ان يترأس الجلسة ساعة
يشاء، لا يقصد بأن يترأس
الجلسات كلها. لأن المشترع
الدستوري، لو اراد ان
يضع السلطة الإجرائية،
اي مجلس الوزراء، تحت
سلطة رئيس الجمهورية،
لكان نص على ذلك. لكن النقيض
كان المقصود تماماً في
تعديلات الطائف التي
كان من اهدافها نقل السلطة
الإجرائية من رئيس الجمهورية
الى مجلس الوزراء. بينما
أظهر الواقع، في السنوات
الأربع الماضية خصوصاً،
رغبة واضحة من رئيس الجمهورية
في ممارسة سلطة لم يلجأ
اليها سلفه الرئيس الياس
الهراوي، علماً بأن الأخير
كان اول رئيس للجمهورية
ينتقل في ممارسة صلاحياته
من الدستور القديم الى
الدستور المعدّل، وادرك
ان السلطة الاجرائية
لم تعد منوطة به بل بمجلس
الوزراء.
فهل ان رغبة
الرئيس لحود تلك، التي
ترجمت في حكومة عهده الأولى
بعد الموجة الاعلامية
التي سبقت انتخابه ورافقت
المرحلة الأولى من ولايته،
لها سند دستوري ووفاقي؟
ولماذا نشأت الخلافات
السياسية الحادة التي
انعكست نتائجها السلبية
على الحكم ككل وعلى البلاد
ككل وعلى القضايا الاقتصادية
والاجتماعية والمعيشية
واصابت الحلول كلها بالشلل،
ومن بينها حلول مؤتمر
باريس 2 الذي كان مؤتمراً
دولياً خاصاً وبارزاً
من اجل مساعدة لبنان على
حل مشكلاته المالية؟
وهل ان واقع
الحكم في لبنان أصبح خارج
المؤسسات نهائياً، الى
درجة انه غدا واقعاً منتجاً
للانقسامات على انواعها،
بلا ضوابط إلا تلك التي
يمكن ان تمارسها سوريا؟
وهل من الطبيعي في بلد
ذي مؤسسات دستورية عريقة
ان تؤدي خلافات المسؤولين
فيه الى تعطيل مسيرة البلاد؟
ولماذا ؟
الجواب هو : اين
المرجع ؟ في كل بلدان
العالم خلافات بين المسؤولين،
حتى في أعرق الديموقراطيات.
وقد شهد العالم كله بين
1997 و 2002، كيف اضطر جاك شيراك
رئيس الجمهورية اليميني
الى المساكنة مع رئيس
وزرائه الاشتراكي ليونيل
جوسبان طيلة خمس سنوات
كاملة، من دون ان تتأثر
فرنسا ومن دون ان يشعر
الفرنسيون بوطأة هذا
الخلاف، لأن كلاً منهما
تقيد بالصلاحيات المنصوص
عنها في الدستور، باعتبار
ان الدستور هو المرجع.
وكذلك هو الحال في بلدان
اخرى مثل الولايات المتحدة
عندما تتغير الأكثرية
في مجلس الشيوخ او في مجلس
الممثلين عن الأكثرية
التي انتخبت الرئيس،
وتبقى الأمور سائرة في
شكل طبيعي.
أما في لبنان،
وفي السنوات الأخيرة
تحديداً، فان النتائج
السلبية للخلافات بين
المسؤولين بلغت هذا المدى
على مستوى البلاد ككل،
لسبب رئيسي هو ان الاحتكام
الى الدستور لم يعد هو
القاعدة. لأن تسوية الخلافات
اصبحت تتم من دمشق. واذا
كان الأمر مفهوماً في
بداية العمل باتفاق الطائف
مطلع عهد الرئيس الياس
الهراوي، فإن استبدال
مرجعية الدستور بمرجعية
سياسية اقليمية، كان
من شأنه ليس استبدال
النص الدستوري بالحل
السياسي فحسب، بل تغيير
مجرى الحياة السياسية
اللبنانية كلها، بصرف
النظر عن تحديد مسؤولية
الوصول الى هذه الحال
التي تنطوي على لبس كبير
بين مصدر القرار وموضع
المسؤولية.
وبما ان الشيء
بالشيء يذكر، لا بدّ من
الاشارة الى انه بعد احداث
1958 ولقاء الرئيسين فؤاد
شهاب وجمال عبد الناصر
في خيمة الصفيح على نقطة
الحدود السورية – اللبنانية
(في عهد الوحدة بين مصر
وسوريا)، نشأت حال من الثقة
والتفاهم والصداقة بين
الرئيسين، كان من نتائجها
المباشرة دعم العمل في
مؤسسات الدولة اللبنانية،
بحيث ان الرئيس جمال عبد
الناصر اصبح بعد ذلك يعتذر
عن عدم استقبال السياسيين
اللبنانيين الذين كانوا
اعتادوا الذهاب الى القاهرة
للاجتماع بالرئيس المصري،
آواخر عهد الرئيس كميل
شمعون وبداية مرحلة المواجهة
معه في احداث 1958، فقد كان
يرسل من يقول لهم : اذهبوا
وقابلوا رئيسكم الرئيس
فؤاد شهاب.
فهناك فرق بين
مساعي التوفيق عندما
يتطلب الأمر ذلك، وبين
ان تصبح هذه المساعي سياسة
دائمة وعلى مدى سنوات
طويلة. لأنه لا بدّ من ان
ينتج من ذلك ارباك واحراج
لسوريا نفسها، فضلاً
عن تراجع عمل المؤسسات
في الدولة اللبنانية
نفسها، مع العلم ان الرئيس
السوري بشّار الأسد شدد
في غير مناسبة على وجوب
احترام عمل المؤسسات.
واذا كان الموضوع
موضوع توازنات، فقد ثبت
ان هذه التوازنات، اذا
تم النظر اليها من خلال
الأشخاص، فانها تتبدل
بحكم التطورات السياسية،
ولذا فان الحرص عليها
يضع الدستور والمؤسسات
جانباً، في سبيل تقوية
هذا واضعاف ذاك. فالدستور
هو الذي يؤمن التوازنات
في البدء، وليس النظرة
الى حجم الأشخاص.
ولم ينس الكثيرون
بعد ما حدث في صيف 2001 بالنسبة
الى قانون اصول المحاكمات
الجزائية، الذي كان صدق
بمادة وحيدة في جلسة 28 آذار
2001، ولكن رئيس الجمهورية
رده واعيد الى المجلس
النيابي بتاريخ 20 نيسان
2001 فصدق عليه المجلس مجدداً
في 30 تموز وصدر بتاريخ 2 آب
2001. وبعد ذلك تقدم عدد من
النواب باقتراح قانون
بصفة معجل مكرر لتعديل
بعض المواد من القانون
الذي سبق للمجلس ان صدق
عليه، فصدقت التعديلات
بتاريخ 14 آب 2001.
فالخضوع لقرارات
المؤسسات، وبخاصة لقرارات
مجلس النواب، لا يمس التوازنات،
لأن تلك هي ارادة ممثلي
الشعب. لا بل ان الخضوع
لها يشرف المسؤولين ديموقراطياً،
ويبرهن ان التصويت ليس
المقصود به شخص المسؤول.
لأن شخصنة التصرفات والمسؤوليات
والتوازنات يعطل عمل
المؤسسات.
ولعل المؤسسة
الأهم التي انيطت بها
السلطة الإجرائية، اي
مجلس الوزراء، شهدت في
السنوات الأخيرة اخطر
انواع الممارسات، حتى
بدا ان التضامن الوزاري
المفروض يضرب الائتلاف
الحكومي الذي كان منذ
البدء قاعدة نشوء الحكومات
في لبنان، وذلك بعدما
تحول مجلس الوزراء الى
قوى متباينة ذات ولاءَات
مختلفة تستحكم بها الخلافات،
فصارت مداولات مجلس الوزراء
تنقل في وسائل الإعلام
بشكل يدل على انه لم يعد
في لبنان حكم موحد الأهداف
والوسائل في سبيل المصلحة
العامة.
فالدعوات المتزايدة
من قِبَل الجميع، وحتى
من هم داخل السلطة، الى
وجوب اعادة الاحتكام
للدستور ولاتفاق الطائف،
تدل على ان الخروج عنهما
كان واضحاً. لأنه اذا لم
يعد لبنان يحكم بقوة دستوره
ومؤسساته فباسم من يحكم؟
ولمصلحة من هذا الوضع
؟ |